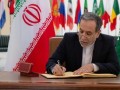الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
اشتداد الخلافات في «البيت الغربي»... اليوم التالي

الدكتور ناصيف حتي
تمر العلاقات في «البيت الغربي»، وتحديداً الأطلسي، بين الولايات المتحدة من جهة والدول الأوروبية الغربية، بشكل عام، من جهة أخرى، في مرحلة يمكن وصفها بالتوتر الناتج عن خلافات في الرؤية الاستراتيجية للنظام العالمي الذي هو في صدد التبلور: نظام ما بعد انتهاء ما عرف بـ«لحظة الأحادية الأميركية»، خصوصاً مع إدارة ترمب التي تعتنق عقيدة استراتيجية تقوم على الأحادية الحادة، ومنطق دبلوماسية الصفقات، على حساب ما يفترض أن تكون رؤية غربية أطلسية مشتركة للأولويات والتحديات الدولية، وكيفية التعامل معها.
حرب أوكرانيا المستمرة، ولو بدرجات مختلفة من الحدة، كشفت عن هذا الاختلاف، فرغم الأولوية الاستراتيجية لهذه الحرب من المنظور الأوروبي، إذ تقع في «المسرح الأوروبي»، فإن موقف الحليف الاستراتيجي الأميركي جاء صادماً، كونه اتجه لاعتناق سياسة براغماتية للتوصل إلى تسوية سلمية مع الجار الروسي، مظهراً أساساً أن أوكرانيا لا تحظى بأولوية في الأهداف الاستراتيجية الأميركية.
وإذا كانت الوقائع والمعطيات الموضوعية تذكر الأوروبيين بأنهم غير قادرين على الاستمرار في توفير كل أوجه الدعم المطلوب والمتزايد لأوكرانيا، لعدم الانكسار أو الاستنزاف الكلي أمام موسكو، دون الدعم الأميركي، فإن الرسالة الأميركية كانت واضحة فيما يتعلق بحدود الدعم وسقفه السياسي، والتوجه نحو العمل لبلورة تسوية، دون أن يشارك في صياغتها الحليف الأوروبي في البيت الغربي. من أهم دروس هذه الحرب المستمرة وكيفية وقفها، اختلاف الأولويات في قضايا استراتيجية أساسية بين واشنطن والأوروبيين.
أزمة أميركية أوروبية أقوى انفجرت حول جزيرة غرينلاند التي هي ضمن السيادة الدنماركية، وذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة القطب الشمالي، مع مطالبة واشنطن بالاستحواذ على هذه الجزيرة. وقد حاولت ذلك عام 1946، وتمت تسوية المسألة حينذاك عبر اتفاق دفاعي عام 1951 مع الدنمارك يسمح لواشنطن بأن تكون لها قواعد عسكرية مختلفة في الجزيرة. الاتفاق حول غرينلاند الذي تم التوصل إليه، ومن غير المؤكد أنه سيطوي صفحة الأزمة بين واشنطن وحلفائها، قوامه التزام الحلف الأطلسي بالدفاع عن القطب الشمالي وإجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة والدنمارك حول غرينلاند للتوصل إلى صيغة جديدة حول هذه المسألة العائدة بقوة مع ترمب. البعض يعدّ أن هذه التسوية بمثابة عملية شراء وقت ما دام الرئيس الأميركي متمسكاً بموقفه. وقد يتم إقناعه بصيغة متطورة من حيث الامتيازات العسكرية والأمنية لواشنطن عن تلك القائمة حالياً، ليتراجع عن هذا الموقف، فكل السيناريوهات ممكنة.
مؤتمر دافوس الأخير عكس بشكل واضح الخلافات في البيت الغربي الأطلسي. خلافات في الرؤى والأولويات وليست خلافات ثانوية يمكن احتواؤها بسهولة أو بإظهار بعض المرونة من هذا الطرف أو ذاك. ترمب ركز على منطق القوة وعقد الصفقات الثنائية على حساب التعاون المتعدد الأطراف، خصوصاً في «البيت الغربي الواحد»، البيت الآخذ في التفكك.
رئيس وزراء كندا، الدولة الجارة والحليفة التاريخية لواشنطن، دعا إلى تعزيز واستنهاض دور «القوى المتوسطة» والتعاون فيما بينها. ويحاول بذلك تقديم رؤية جديدة لإدارة العلاقات الدولية في نظام دولي ما زال، كما أشرنا، في دور التشكل.
رئيسة المفوضية الأوروبية صرخت في دافوس: «عاشت أوروبا»، بما يحمله هذا الشعار من دعوة لدور جديد، في لحظة تعيش فيها أوروبا أزمات داخلية متعددة الأوجه والأبعاد في السياسة والاجتماع والاقتصاد. وتتعرض كل يوم لتهديدات بحرب اقتصادية من الحليف الأميركي، فيما نجحت مؤخراً في تحقيق إنجاز اقتصادي استراتيجي كبير على الصعيد الدولي، من خلال توقيع اتفاقية تعاون تجاري مع مجموعة «المركوسور» في أميركا الجنوبية. اتفاقية ذات أبعاد استراتيجية اقتصادية وتجارية كبيرة، نظراً للثقل الديمغرافي والاقتصادي والجغرافي الذي يشكله الطرف الأميركي الجنوبي.
تطورات في أشكالها وأبعادها المختلفة تحمل مؤشرات، وتشكل سمات للنظام الدولي الجديد، الذي هو في طور التبلور.
GMT 04:58 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
مَن رفع الغطاء عن سيف؟GMT 04:57 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
بقعة خلف بقعةGMT 04:51 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
الملك فاروق... إنصافٌ متأخرGMT 04:45 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
لماذا غاب الإسرائيليون عن قوائم إبستين؟!GMT 04:42 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
كيف تواجه إدارة النصر غياب رونالدو؟GMT 04:40 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
في مصلحة مَن تقسيم إيران؟GMT 04:37 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
في انتظار «الأنبياء الكذبة»!GMT 04:35 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
ليبيا... دُفنَ سيف وبقيتْ طوابيرُ المعاناةترامب يوقع أمراً تنفيذياً لفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران
واشنطن ـ مصر اليوم
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمراً تنفيذياً يتيح للحكومة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 25% على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران و...المزيدمي عمر تحتفل بنجاح برومو مسلسل الست موناليزا و توجه الشكر لفريق عمل
القاهرة - مصر اليوم
إحتفلت الفنانة مي عمر بنجاح الإعلان الدعائي لمسلسل "الست موناليزا" والذي تم طرحه خلال الفترة الماضية، كما أنها وجهت الشكر لفريق عمل المسلسل مُتمنية أن ينال إعجاب الجمهور. مي عمر توجه الشكر لفريق عمل مسلسل "ا...المزيدالاتحاد الأوروبي يحث "تيك توك" على تعديل تصميمه الإدماني أو مواجهة غرامات ضخمة
بروكسل ـ مصر اليوم
حثّت المفوضية الأوروبية منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك على إجراء تغييرات جوهرية في تصميم التطبيق، الذي اعتُبر من بين أكثر التطبيقات تحفيزًا للإدمان الرقمي، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين. وجاءت هذه التحذي...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©