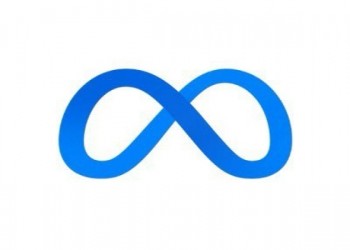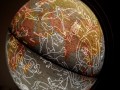الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
العالم جُنّ.. التكنولوجيا دمرت الأخلاق

بقلم: أسامة الرنتيسي
فعلا؛ العالم جُن، وأصبح تسيطر عليه التكنولوجيا التي دمرت الأخلاق، ونزعت من الإنسان الصدق حتى مع ذاته.
مفزع جدا عندما ترى شخصا يتصور سيلفي بالقرب من سرير والده المتوفى، أو ابنه بعد عملية جراحية صعبة، أو يقبل يد والدته وهي في النزع الأخير.
وصل الأمر أن يتم نقل الدفن عبر خاصية البث المباشر في الفيس بوك، وتصل الكاميرا إلى داخل اللحد وهو مسجى ويُهال عليه التراب.
قبل فترة أقدم شاب سوري ثلاثيني على الانتحار من عن جسر عبدون، يومها أُقسم بالله أنه وصل تلفوني أكثر من 30 فيديو يصور المنظر.
ما فجعني فوق فاجعة الانتحار، نوعية الأعصاب ومستوى الأخلاق عند من صوّر الفيديو من الجهة المقابلة للجسر.
كأننا إزاء مشهد تمثيلي حقيقي، شاب يقترب بكل جرأة من “جسر الانتحار” تقف خلفه سيارة دفاع مدني في محاولة لمنعه من الانتحار، لم ينتظر الشاب وصول أحد إليه، تدلى من أعلى الجسر كأنه يريد السقوط لا الانتحار، لأنه لم يقفز كما يفعل المنتحرون بل تدلى قليلا وترك لنفسه العنان، فسقط من على الجسر وانفجر على الأرض كما تنفجر بِطِّيخَة.
هذا المشهد لو كان في فيلم سينمي لاستحق عليه المخرج جائزة، أما أن يجد أحد الهواة في الجهة المقابلة للجسر فرصته بتصويب هاتفه ومتابعة الشاب وهو يقرر الانتحار، فهذا مشهد لا يمكن اختزاله في شخص هاوٍ بل محترف يتعامل مع الموت بكل هدوء وسكينة.
مشهد تصوير حالة الانتحار لا تختلف كثيرا في فجاعتها عن مشهد العشرات عندما يحملون هواتفهم ويصورون جثث ضحايا حوادث الطرق، بعضهم يستخدم الزووم حتى يصل لأدق التفاصيل في تصوير حالة الضحايا والمصابين.
هل فعلا ضريبة التكنولوجيا، وهوس اللايكات، ونشر الفيديوهات، والتسابق في البث والإرسال وغزو الجروبات أكثر تأثيرا في ثقافتنا الجديدة، تعادل مشاعر الإحساس مع الضحايا والمصابين، وكأننا إزاء مشاهد عادية لا يتأثر المرء بها أبدا.
هل فقدنا حاسة التعاطف والتضامن مع الضحايا، ماذا كسب مصور فيديو الانتحار من بثه في الفضاء الإلكتروني، وما هو المكسب الذي يحصل عليه كل من يقوم بإعادة بث الفيديو على مجموعاته والجروبات المشارك فيها.
لم يعلم أحد ما هي الأسباب التي تدفع شابا ثلاثينيا إلى اتخاذ قرار ترك الحياة ومغادرتها بكل هذا البرود، عن سبق إصرار، لا نعلم حجم القهر الساكن في قلب ونفس هذا الشاب السوري، ولا ظروف حياته وأهله في الأردن.
الدايم الله….
GMT 09:56 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
ردّة أخلاقيةGMT 09:55 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
أميركا... ثقافة قديمة وعاديةGMT 09:53 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
عن الحالتين الفلسطينية والسودانيةGMT 09:52 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
لبنان... جولة جنوبية للطمأنةGMT 09:50 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
تشخيص طبيعة الصراع بين أميركا وإيرانGMT 09:49 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
تركيا و«شيفرون»... رهان أنقرة الجديد في عالم الطاقةGMT 09:47 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
لبنان... المطلوب إصلاح جذري قبل الانتخاباتGMT 09:45 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
هل ينجح ترمب في تفكيك قنبلة نتنياهو؟تراجع معدل التضخم في مدن مصر لـ 11.9% خلال شهر يناير
القاهرة ـ مصر اليوم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى نسبة 11.9% على أساس سنوي في يناير 2026 من قراءة ديسمبر025 2والبالغ نسبتها 12.3%. وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم الشهري في مصر �...المزيدأصالة تكشف تفاصيل ألبومها السوري الجديد ومشاركتها في رمضان 2026
القاهرة ـ مصر اليوم
أحيت الفنانة أصالة حفلًا غنائيًا في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، وعلى هامش الحفل عقدت مؤتمرًا صحفيًا تحدثت خلاله عن أحدث مشاريعها الفنية، سواء الغنائية أو الدرامية، كاشفة عن تفاصيل ألبومها السوري الجديد، إلى جا�...المزيدنظر دعوى قضائية تتهم شركات ميتا ويوتيوب بالتسبب في أضرار للأطفال
واشنطن ـ مصر اليوم
بدأت محكمة أمريكية في دراسة دعوى قضائية مثيرة للجدل تتهم شركتي ميتا ويوتيوب بالإضرار بالأطفال من خلال محتوى منصاتهما الرقمية. وتستند الدعوى إلى مزاعم بأن المنصات لم تتخذ التدابير الكافية لحماية المستخدمين الصغار ...المزيدجهود مؤسسية لحماية التراث في ندوة ثقافية بأيام الشارقة التراثية
الشارقة ـ مصر اليوم
على هامش فعاليات أيام الشارقة التراثية، استعرضت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جهودها المؤسسية في صون التراث الثقافي وتعزيز التعليم الثقافي، وذلك خلال ندوة نظمها المقهى الثقافي في بيت النابودة بعنوان «الجهو...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©