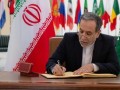الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
بين السياسة والرياضة.. صلاح بعد العاصفة!

بقلم: عبد الله السناوي
عند ذروة أزمته العاصفة نشر على «إنستجرام» صورة غامضة لأشجار خريفية وقد تساقطت أوراقها. أراد أن يقول إنه مستعد لأن يغادر ليفربول الآن، وأنه لن يعتذر مهما كانت الضغوط عليه.
رغم تجاوز حدة الأزمة، فإن ظلالها ما زالت ماثلة، وأسئلتها الرئيسية تأجلت الإجابات عنها إلى ما بعد عودته من بطولة الأمم الإفريقية (2025) بالمغرب.
هل أخطأ فى نقل أزمته مع مدربه «أرنى سلوت» إلى العلن، مخترقًا قواعد الاحتراف المفترضة؟ أم أنه قصد كل حرف قاله حتى لا يتحمل وحده مسئولية التراجع الكارثى فى مستوى الفريق، أو أن يكون كبش فداء لأخطاء غيره؟
تعددت الإجابات، وتداخلت الاعتبارات السياسية فى المشهد الرياضى العالمى.
كانت ردة الفعل المصرية شبه إجماعية على نصرة «محمد صلاح» «ابننا»، كما يوصف عادة. وفى الوقت نفسه، تبدت أصوات تشمت فيه لأسباب أيديولوجية وتنظيمية.
نُسبت إليه تُهم، بعضها يستحق التوقف عنده بالنقاش والاستبيان لما يقدر عليه وما لا يقدر، مثل موقفه من قضية غزة، وبعضها الآخر لا يستحق أدنى التفات، مثل الاحتفال بالكريسماس والعزاء فى رحيل ملكة بريطانيا «إليزابيث الثانية»!
إنها حالة ترصد لاغتياله معنويًا بصورة غير مسبوقة من الكراهية المعلنة دون سبب مقنع أو متماسك، سوى أنه لم يلتحق تنظيميا بهم.
هناك فارق جوهرى بين أن تعاتب وتنتقد، وبين أن تمعن فى الكراهية دون استبيان أو إنصاف.
السؤال الجوهرى هنا: لماذا تقف الأغلبية الساحقة من المصريين فى صفه، إلى درجة مقاطعة مباريات ليفربول، التى دأبت المقاهى والمنتديات العامة على بثها، كما رصدت فضائيات ووكالات أنباء دولية؟
فى الحالتين المتتاليتين، المقاطعة ثم العودة عندما بدا أن الأزمة أوشكت على الانقضاء، تأكدت معانٍ ورسائل.
ظاهرتُه تحتاج إلى دراسات وبحوث ميدانية وموضوعية فى علوم النفس والاجتماع والسياسة، تنظر فى أسبابها العميقة التى جعلت ممكنًا القول إنه «لا يوجد شىء آخر يبهج ويوحد المصريين غيره».
هذا القول الشائع ينطوى على رسالتين متناقضتين: الأولى إيجابية من زاوية الاعتزاز الوطنى بأى إنجاز على مستوى دولى، علمى أو دبلوماسى أو أدبى أو فنى أو رياضى، يحققه مواطنون لديهم الموهبة والكفاءة والقدرة على الإبداع. والثانية سلبية من زاوية الشعور بأنه لا يوجد شىء آخر يبهج أو يوحد أو يعطى أملًا بالمستقبل.
لا يصح تحميل «صلاح» فوق طاقته، أو تسييس ظاهرتِه خارج طبيعتها الأصلية؛ فهو فى البدء والمنتهى لاعب كرة قدم تمكن من إحراز مكانة متقدمة فى اللعبة الأكثر شعبية بموهبته والعمل على تطوير قدراته.
قبل أن تنجلى حقائق ما يجرى فى كواليس ليفربول، بدا الانحياز الشعبى واضحًا. وحسب ما هو ظاهر، فإنه اخترق قواعد الاحتراف بالاعتراض على جلوسه ثلاث مباريات متتالية على دكة البدلاء.
هذا شأن المدير الفنى وحده، والأزمة تُدار فى غرفة الملابس لا خارجها. النقد صحيح فى عمومه، وإلا أفلتت أى سيطرة على اللاعبين، لكن ما حدث كان شيئًا آخر.
حسب ما بدأ يتسرب من الغرف المغلقة، فإنه كان يدافع عن إرثه حتى لا يخرج من الباب الخلفي، كأنه لم يكن صاحب الفضل الأول فى إكساب ليفربول مكانته كواحد من أقوى الفرق الأوروبية.
وباعتراف «يورجن كلوب»، مديره الفنى السابق: «إنه واحد من أعظم اللاعبين على مر العصور».
من حق «صلاح» كنجم فوق العادة أن يبرئ نفسه أمام جمهوره، ويكشف بعض ما يجرى فى الكواليس، كعدم الوفاء بالوعود التى قُطعت له عند تجديد عقده العام الماضى.
عبّر عن إحباطه قائلًا: «أشعر كما لو أُلقى بى تحت الحافلة». ثم ألمح إلى أن هناك شخصًا ما وراء تصعيد الأزمة.
لم يقصد المدير الفنى «سلوت»، فهو واجهة قرار تهميشه، وليس صاحبه. قصد مباشرة المدير الرياضى «ريتشارد هيوز»، ومن خلفه «مايكل إدواردز»، الرئيس التنفيذى لكرة القدم فى مجموعة «فينواى» الرياضية المالكة للنادى.
إنهما مركزا النفوذ والتأثير داخل ليفربول، اللذان تمكنا من إطاحة المدير الفنى السابق «كلوب»، الذى لم يذعن للاستراتيجية التى أرادا فرضها.
بدا تهميش «صلاح» مقصودًا لهدفين: الأول تحميله مسئولية تراجع النتائج، وإعفاء «سلوت» من أى مسئولية. تراجع فعلًا مستواه هذا الموسم، لكنه لم يكن وحده.
والثانى إسناد فشل صفقات «الميركاتو الصيفى» إليه، وقد كلفت خزينة النادى أكثر من نصف مليار دولار، كأن من مهامه وضع الخطط وتوظيف الإمكانيات والمواهب التى جُلبت.
كانت تلك رسالة إلى جمهوره تمهيدًا لبيعه فى «الميركاتو الشتوى» يناير المقبل، حتى لا تكون هناك أية ردة فعل غاضبة.
حسب تسريبات غير مؤكدة، جرت اتصالات مع أندية سعودية دون إخطار وكيل أعماله، كما تقضى أصول الاحتراف.
لم يتجاوز «صلاح» أصول الاحتراف، لكن غيره فعل ذلك.
هكذا بدت كل أطراف الأزمة فى مأزق محكم، وليس «صلاح» وحده. هذه حقيقة يصعب إنكارها.
وهو يريد أن يخرج من الباب الكبير، مكرمًا ومعززًا، لا مهانًا أو مهمشًا. وهذه حقيقة أخرى.
ترددت استنتاجات عن دوافع عنصرية فى معاملته بلا الاحترام الذى يستحقه، ترتيبًا على إرث التاريخ المرير للإمبراطورية البريطانية السابقة.
هذه المسألة بالذات تستحق دراسة أعمق لظاهرتِه فى المجتمع البريطانى، وحدودها فى تغيير الصور النمطية عن العالم العربي، ومصر بالذات.
ومما لا يمكن تجاهله إنتاج أغنية جديدة من جمهور ليفربول، تنحاز إليه وتتبنى موقفه. ليفربول هى مدينة «البيتلز»، وقد عبّرت عن موقفها بالغناء.
وسط ضجيج المساجلات حول مستقبله، رشحته هيئة الإذاعة البريطانية لنيل شخصية العام الرياضية (2025). وكان ذلك تكريمًا مستحقًا فى وقت أزمة عاصفة.
GMT 02:18 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
لعنةُ إبادة غزة وارتداداتُهاGMT 02:16 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
فارق الوقت وفالق الزلازلGMT 02:15 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
موضعٌ وموضوعٌ: وتُرْكٌ ورَهْطُ الأعجمين و«كابُل»GMT 02:13 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
لنعدّ أنفسنا لواقع جديد!GMT 02:12 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
نندم... لكنْ ماذا بعد الندم؟GMT 02:11 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
عامٌ خامسٌ من الحربِ ولا سَلامَ في الأفقGMT 02:10 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
رمضان والمجتمعGMT 02:09 2026 الأحد ,01 آذار/ مارس
متحف الأوهامالحرس الثوري يعلن توقف الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية عالميا
واشنطن - مصر اليوم
تزامنا مع الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، أعلن الحرس الثوري، السبت، عن إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط، ويعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ووجهت القوة البحري�...المزيدهاني شاكر في غرفة العناية الفائقة بعد عملية جراحية تسببت بنزيف حاد
القاهرة ـ مصر اليوم
مازال الفنان المصري هاني شاكر يرقد بغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالجيزة، بعد أن خضع لجراحة دقيقة بالقولون، و إصابته بنزيف شديد خلال الأيام القليلة الماضية. وكشف مصدر مقرب من أسرة للفنان المصري، أ...المزيدإسرائيل تخترق تطبيق إيراني لمواقيت الصلاة وتدعو العسكريين للانشقاق
طهران - مصر اليوم
في تصعيد غير مسبوق على الجبهة السيبرانية، استُخدم تطبيق إيراني شهير لمواقيت الصلاة لإيصال رسائل تدعو عسكريين إلى الانشقاق، في خطوة تزامنت مع الضربات العسكرية الأخيرة على إيران. وأفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل اخت�...المزيداستقالة مديرة متحف اللوفر على خلفية حادثة سرقة جواهر التاج البريطاني
باريس ـ مصر اليوم
استقالت مديرة متحف اللوفر الشهير في باريس، الثلاثاء، على خلفية سرقة جواهر التاج البريطاني التي بلغت قيمتها 88 مليون يورو (100 مليون دولار) العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "سرقة القرن". وأعلن الرئيس الفرنسي إي...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©