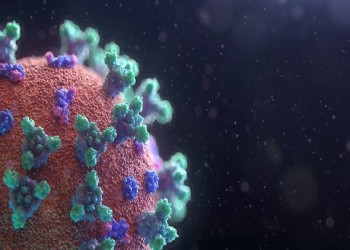الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
مئوية أهم دستور مصرى

بقلم - مصطفي الفقي
الدستور هو أب القوانين ولمصر تاريخ مشرف بالتعامل مع هذا المفهوم بمعناه الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر، لكن يظل دستور 1923 هو أهم دستور مصرى لأنه جاء تعبيرًا عن الإرادة المباشرة للشعب المصرى عقب ثورته عام 1919، كما ارتبط بإعلان الاستقلال، وتنبع أهمية ذلك الدستور من أن كل طوائف الشعب وقطاعاته كانت ممثلة فى اللجنة التحضيرية له فكان الأزهر حاضرًا وكانت الكنيسة موجودة بل إن حاخام اليهود المصريين قد شارك فى مناقشات الإعداد لذلك العمل الوطنى الذى وضع خطة المستقبل أمام مصر الليبرالية فى العصر الملكى، ورغم طغيان العرش والانجليز على ذلك الدستور الذى لم تشهد له مصر مثيلًا والذى ألغاه إسماعيل صدقى عام 1930 واصطنع حزبًا كرتونيًا باسم حزب الشعب لكى يضرب الوفد الذى هو وعاء الحركة الوطنية وليأتى بدستور لقيط لم يصمد لأكثر من ثلاث سنوات، وظل الشعب المصرى معتزًا بدستور 1923 الذى كان يتوازى مع الدساتير الأوروبية ويتواكب مع صحوة العالم المعاصر عقب الحرب العالمية الأولى، ولقد ظل ذلك الدستور 1923 أيقونة للحريات وحارسًا للديمقراطية ومعبرًا عن إرادة الشعب حتى قيام ثورة يوليو 1952، حيث تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال ولكن بقيت رائحة صفحات ذلك الدستور وسطوره بمثابة تراث ديمقراطى موروث لدى الأجيال المصرية بل والعربية أيضًا تستلهم من نصوصه مرشدًا للحاضر ونبراسًا للمستقبل، إنه الدستور الذى خسر فى وجوده يحيى إبراهيم باشا رئيس الوزراء مقعده فى دائرته الانتخابية بـ(منيا القمح) تأكيدًا للديمقراطية وتعبيرًا عن التحول الذى جرى فى شخصية المصريين، ولا أظن أن ذلك الدستور العريق قد ترك شاردة أو واردة إلا وعالجها فى إطار النظام الملكى بالطبع لذلك كان إلغاء العمل به تمهيدًا ضروريًا لإعلان الجمهورية بعد ثورة 1952، حيث توالت الإعلانات الدستورية التى سعت فى معالجة أحداث طارئة أو أوضاع عابرة وتوالت الدساتير المؤقتة والدائمة على مصر فى أحوالها المختلفة ولكن بقيت النظرة لدستور 1923 باعتباره الدستور الملهم والنقلة النوعية فى الفكر السياسى المصرى المعاصر، ولذلك فإننى أدعو كل من يمتلك رأيًا فى دستور 1923 أو تحليلًا لأحد فصوله أو تعليقًا على أحد بنوده، أطالبهم جميعًا بأن يدلو بدلوهم فى هذا الشأن، فهذا العام الذى نحتفل فيه بمئوية دستور 1923 يجب أن يكون مراجعة أمينة منا جميعًا لمجمل الأفكار المطروحة والحصاد لكل القضايا المنظورة ولندرك أن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هى امتدادات لمبادئ ذلك الدستور الخالد فى تاريخنا المعاصر، ولنتذكر دائمًا أن حركة الأحزاب السياسية والحديث عن الحريات وصيانة الحقوق والالتزام بالواجبات هى كلها روافد لذلك الدستور الذى كلما قرأناه وبعد عشرات السنين من صدوره نشعر بأنه يتحدث عن واقع الحال فى مصر فهو دستور سابق لعصره متقدم على وقته ومعبر أصدق تعبير عن الحاجة الملحة لقيام نظام برلمانى مصرى يؤمن بأن الأمة مصدر السلطات، وأن الأحزاب السياسية أدوات مساعدة فى إطار التطور الطبيعى وفقًا لما ارتآه أساتذة القانون الدستورى وشراح النص المعاصر، وفى مقدمتهم الفرنسى (موريس دوفرجيه)، فالقانون كائن حى ينمو ويتطور ويحتاج إلى مراجعة بما لا يمس الثوابت المتصلة بالحريات وتداول السلطة ودوران النخب فى كافة الميادين، ولنتذكر الآن أن مساحة الحرية التى كفلها دستور ما بعد الثورة الشعبية عام 1919 بإفرازاتها المؤثرة، بدءًا من مساحة الحرية المتاحة والتى سمحت لمفكر كبير مثل عباس محمود العقاد أن يقول تحت قبة البرلمان عباراته الشهيرة (أننا مستعدون لسحق أكبر رأس فى البلاد إذا اعتدى على الدستور أو تجاوز حدوده المرسومة وفقا لها)، وعلى الرغم من أن العقاد قد دفع الثمن لهذه العبارة الجريئة فى وقتها إلا أن الأمر فى مجمله يؤكد أن مساحة الحرية كانت تحاول التوسع فى ظل عرش يحكم بلا وعى، ويدير البلاد دون الانخراط فى مسار الطبقات الشعبية، أو فهم إرادتها، رغم الرغبة العامة فى الإصلاح وتحسين الأوضاع والمضى بالبلاد إلى ماهو أفضل، وقد برزت زعامات مصرية وطنية فى مقدمتها زعيم الثورة سعد زغلول وخليفته الوطنى مصطفى النحاس فى عصر ميلاد الأفكار السياسية الكبرى والحركات الجماهيرية، بدءًا من حزب الوفد – وعاء الحركة الوطنية حينذاك - مرورًا بجماعة الإخوان المسلمين منذ 1928 وصولًا إلى أحزاب الأقلية فى عصر ارتبطت فيه السياسة بالثقافة حيث شاهدنا نماذج من كبار المثقفين والمفكرين ترتاد الحياة السياسية وتمضى معها باتجاهات فكرية تنويرية، بدءًا من أحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل وطه حسين وغيرهم ممن أثروا الحياة السياسية والفكرية فى وقت واحد، وعندما حصل الانشقاق فى حزب الوفد فوجئ المصريون بأن الوحدة الوطنية المصرية التى هى بنت ثورة 1919 قد أصبحت راسخة وعميقة الجذور فى الكيان المصرى الكبير، فعندما وقع الخلاف الوفدى بين مصطفى النحاس، باشا ومكرم عبيد باشا وجدنا أن أغلبية الأقباط فى الوفد قد ظلوا تحت لواء النحاس، بينما خرجت مجموعة من المسلمين الوفديين لدعم جناح مكرم عبيد والانضمام إلى حزبه الجديد (الكتلة) بما يعنى أن التقسيم الدينى قد سقط، وأن الخلاف السياسى أصبح هو الفيصل، ولم يكن لذلك أن يحدث لولا دستور 1923 حارس القيم وراعى التقاليد وحامى مبادئ 1919 التى ظلت تعتمد على مبادئ الوحدة الوطنية والشرعية الدستورية مع مسحة ليبرالية علمانية يشعر بها كل قارئ للفترة بين الثورتين 1919-1952، سواء فى السياسة أو الأدب أو الفن أو الصحافة، فتلك كلها مواليد شرعية للدستور العظيم الذى يجب أن نحتفل بمئويته هذا العام.
GMT 20:35 2025 السبت ,08 شباط / فبراير
48 ساعة كرة قدم فى القاهرةGMT 20:18 2024 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
مؤتمر الصحفيين السادس.. خطوة للأمامGMT 14:59 2024 الثلاثاء ,03 أيلول / سبتمبر
مشاهد مُستَفِزَّة.. “راكبينكم راكبينكم..”!GMT 06:36 2024 الأحد ,25 آب / أغسطس
… لأي قائمة يسارية ديمقراطية نصوت ؟!GMT 06:23 2024 الأحد ,25 آب / أغسطس
ماذا قال يمامة؟اجتماع مرتقب للبنك المركزي المصري وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة 1%
القاهرة - سعيد الفرماوي
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماعاتها خلال عام 2026 برئاسة المحافظ حسن عبد الله، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تراجع معدلات التضخم وتزايد التوقعات باتج�...المزيدالبنتاغون يسعى لفك قيود الذكاء الاصطناعي على الشبكات السرية
واشنطن - مصر اليوم
ذكر مصدران مطلعان أن وزارة الدفاع الأميركية تضغط على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، لجعل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متاحة على الشبكات المصنفة على أنها "سرية" دون القيود القياسية الكثيرة التي تفرضها ال�...المزيدمقتنيات المتحف المصري نموذج طائر خشب الجميز يحاكي رحلة الروح المصرية
القاهرة ـ مصر اليوم
في القاعة 22 بالدور العلوي من المتحف المصري، يقف نموذج طائر نادر يأسر الأنظار، ضمن مجموعة استثنائية من نماذج الطيور التي اكتُشفت في سقارة عام 1898. هذه المجموعة ليست مجرد قطع فنية، بل نافذة صغيرة على معتقدات المصريين �...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©