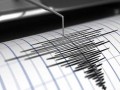الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
السيناريو الألماني

بقلم: سوسن الأبطح
التدابير التي تتخذها وزارات التربية، على أعتاب عام دراسي جديد، على أهميتها، لا تزال أضعف من أن تطفئ القلق الساكن في النفوس، والحيرة مما ستحمله الشهور المقبلة. صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الشهيرة المعروفة بكاريكاتيرها المسيء، نشرت رسماً متحركاً لتلميذين يقفزان فرحاً، وهما متوجهان إلى المدرسة، يحملان على ظهريهما شنطتين، سرعان ما تتحولان إلى تابوتين كبيرين، مع عبارة «هل سيكملان العام»؟ سؤال لا بد يعود حاداً بعد أن سبقت ألمانيا الجميع إلى فتح صفوفها، واستقبال أطفالها. ألمانيا، التي صارت في أوروبا نموذجاً للنجاح في محاربة الوباء، والتغلب عليه بأقل عدد من الضحايا، وأصغر قدر من الخسائر الاقتصادية، تعيد إغلاق بعض من مدارسها بعد أيام قليلة على انطلاقتها. العيون تشخص إلى هناك. فكيف لدول أقل كفاءة من ألمانيا أن تنجح فيما أخفقت فيه بلاد الدقة والإتقان والاحتواء. كان الصيف تحضيراً قاسياً، ورسماً لخرائط العودة الآمنة، التي التزمت الأقنعة والتهوية المستمرة، والتعقيم والتباعد، لكن بعد أيام من التدريس، جاءت النتائج صادمة. أرسلت 4 مؤسسات تعليمية جميع طلابها إلى منازلهم، وخضع 30 مدرسة أخرى لإغلاق جزئي، وأصيب نحو 30 مدرساً وما يقارب 400 طالب بالفيروس. أضف إلى ذلك 350 معلماً على الأقل وما يناهز 6 آلاف طالب هم اليوم في الحجْر الصحي، يمنعون من مغادرة مساكنهم. علماً بأن ألمانيا لا تزال تسجل عدداً من الإصابات قليلاً، إذا ما قورن بفرنسا أو إيطاليا وإسبانيا. دول تستعد لعودة أصحاب الإجازات إلى أعمالهم، وانتقال للمواطنين من مناطق إلى أخرى، وتحبس الأنفاس، أمام تهديد الموجة الثانية التي يعتقد أنها لن تكون أقل شراسة من الأولى.
العينة الألمانية ترسم غيوماً سوداء داكنة، لا يريد أن يراها بهذه القتامة وزراء التربية والصحة في غالبية دول العالم، وهم يعدون مواطنيهم بإجراءات احترازية ستقهر الوباء، ويطمئنون إلى أن الأقنعة الواقية والمسافات الآمنة، وتقليل عدد الطلاب في الصفوف، والنظافة، كلها أمور ستجعل العام الدراسي الجديد، مختلفاً عن الغابر السيئ الذكر.
من غير المفهوم كيف تم التراجع بهذه السرعة، عن نظرية أن الأولاد هم المسؤولون بشكل أساسي عن نقل الوباء بسبب أعراضهم الصامتة، إلى التسليم من دون دليل علمي واضح، بأن الصغار لا يشكلون خطراً كبيراً، لأن من لا تظهر عليه أعراض المرض لا ينقله إلا لماماً. ويخشى بعد التجربة الألمانية، أن يكون ما نسمعه مجرد اجتهادات خنفشارية، فيها كثير من النفاق، بعد أن تبين عجز البشرية، وضعفها، وقلة حيلتها، أمام الأوبئة، وقسوة الإنسان على أخيه الإنسان.
لم يسبق أن رأينا في أعمارنا، عاماً دراسياً، يدشن بهذا القدر من الغموض والتجريبية. ملايين التلامذة حول العالم سيحملون شنطهم بدءاً من مطلع سبتمبر (أيلول) ويسيرون بها صوب صفوف لا أحد يعلم كيف سيتجول «كورونا» في أنحائها، ولا كيف سيتغلب الأساتذة على محنة إبعاد الأطفال بعضهم عن بعض، ومنعهم من تقاسم الحلوى، أو تبادل الألعاب، واستعارة الممحاة والمبراة، وقضم القلم للتفكير في حل مسألة حسابية.
يتساوى البشر في المحنة، وتتباين القدرة على مواجهتها، غير أنك بقليل من البحث تتأكد أن الصيف غدر بمن ظنوه قاتلاً لـ«كورونا»، وها هو الخريف يداهم الجميع، وهم لا يزالون عراة أمام الجائحة.
6 لقاحات قيد التجريب والترويج والمبارزة السياسية، لا حلّ في الأفق. منذ فبراير (شباط) الماضي لا سلاح لنا غير هذا القناع الخانق. غاية ما يتم العمل عليه اليوم، هو إيجاد فحوصات سهلة وسريعة، يتمكن من خلالها الفرد معرفة إصابته وعزل نفسه قبل أن يجني على الآخرين. لكن هذا قد يجعل الوباء أخبث لأنه لن يعطي بالضرورة النتائج الصحيحة بنسب كافية. كل الوسائل مباحة؛ من الكلاب المدربة على كشف الفيروس، إلى حبس كبار السن في المنازل، وصولاً إلى التضحية بعدد كبير من الأرواح لإنقاذ الاقتصادات المتهالكة.
بعض الدول العربية أخرت البدء بالعام الدراسي، ربما بانتظار غودو، أو لتوفير التجربة الوطنية بمراقبة ما سيحدث في مواطن أخرى، والإفادة المجانية من محاولات تكلف غالياً. وبين من استسلم للتعليم عن بُعد من دون الدخول في المجازفة، ومن قرّر تجاهل الجائحة والمضي في فتح الصفوف، ثمة من قرر انتهاج الطريقتين معاً. وفي كل الحالات يُرجى ألا يكون العام الدراسي المقبل أصعب من سابقه. وكل ما يملكه المسؤولون اليوم هو الاعتراف بأنهم يتعاملون مع الفيروس المحير، يوماً بيوم، ولا يملكون للبلاء الجديد دفعاً. هذا في أفضل الدول وأكثرها تقدماً. أما لو يممت وجهك شطر دول قهرها الزمن وجار عليها الدهر، مثل لبنان، فستجد نفسك في متاهة. فقد جنى الانفجار على مدارس يصل عدد طلابها إلى 80 ألف تلميذ، وهؤلاء يحتاجون سقفاً ليتعلموا. أما الباقون فالتعليم عن بُعد لن يرحمهم بسبب شحّ الكهرباء وغلاء الإنترنت. أما التعليم التقليدي في بلاد الأرز، فهذا أيضاً دونه عقبات، لأن الكتاب المدرسي الورقي نفسه ليس متوفراً بعد لهذه السنة، بسبب غلاء الأسعار وندرة الدولار، وقد يرتفع سعره 10 أضعاف.
بقليل من التأمل، يمكنك حقاً أن تعتبر أن «كورونا» ليس نهاية العالم، وثمة ما هو أفظع وأشنع.
GMT 23:29 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
نحو قانون متوازن للأسرة.. بيت الطاعةGMT 23:27 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
نحن عشاق «الكراكيب»GMT 23:25 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
التوت و«البنكنوت»GMT 20:38 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر
الصفقة مع ايران تأجلت... أو صارت مستحيلةGMT 07:51 2021 السبت ,11 أيلول / سبتمبر
الملالي في أفغانستان: المخاطر والتحدياتمجلس النواب الأميركي يفشل في تمرير مشروع لحماية تعريفات ترامب
واشنطن ـ مصر اليوم
فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون كان يهدف إلى حماية تعريفات الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تؤكد الانقسامات السياسية الحادة داخل الكونغرس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان المشروع يسعى إلى تقديم ح�...المزيدحمادة هلال يختتم رحلة "المداح" بالجزء السادس والأخير مع أحداث مثيرة ومفاجآت تشوق الجمهور
القاهرة ـ مصر اليوم
يواجه "صابر" الاختبار الأصعب منذ بداية رحلة مسلسل "المداح" قبل 5 مواسم، حينما يعود في الموسم السادس منه تحت عنوان "المداح أسطورة النهاية".يقف بطل المسلسل، الذي يعرض حصرياً عبر شاشة "MBC مصر" في شهر �...المزيدتحذيرات من مخاطر اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي في تقديم معلومات طبية
واشنطن ـ مصر اليوم
ينظر إلى الذكاء الاصطناعي الطبي بوصفه أداة واعدة لتحسين الرعاية الصحية، ومساعدة الأطباء على اتخاذ قرارات أدق وأسرع. لكن دراسة علمية جديدة تُثير تساؤلًا مقلقًا: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمرر معلومات طبية خاطئة و...المزيداكتشاف 20 ألف قطعة نقدية فضية خلال أعمال ترميم قصر تاريخي في موسكو
موسكو ـ مصر اليوم
عثر عمال ترميم على نحو 20 ألف قطعة نقدية فضية أثناء تنفيذ أعمال صيانة داخل قصر تاريخي في العاصمة الروسية موسكو، في اكتشاف أثري وصفه الخبراء بأنه من أبرز الاكتشافات النقدية في المدينة خلال السنوات الأخيرة. وجرى العث�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©