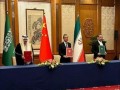الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
في معرض الكتاب.. الروايةُ تفتحُ لي بابَها

بقلم: فاطمة ناعوت
هناك كتبٌ نقرأُها، وكتبٌ نكتبُها، وكتبٌ تظلُّ سنواتٍ تقف فى الظلِّ، تراقبُنا، تنتظر أن ننضجَ بما يكفى لنحتمل ثِقَلَ أوراقها. ربما هذه العبارة هى الردُّ الحاسم لكل مَن سألنى: «لماذا تأخرتِ، ولماذا دخلتِ عالمَ الرواية، بعد تمنّع امتدَّ ربع القرن قضيتِه فى دروب الشعر والترجمة والصحافة والنقد الثقافى؟» والحقُّ أننى لم أدخل «الرواية» متأخرةً، بل دخلتُها فى موعدها الخفىّ.
هذا العام، وأنا أخطو من بوابة «معرض القاهرة الدولى للكتاب»، شعرتُ أننى لا أزوره كعادتى، بل أُستَقبَل فيه. كأن المكان يعرف عنى سرًّا، ينتوى إفشاءه. سمعتُ القاعاتِ والأجنحةَ ورفوف الكتب تهمسُ لى: «الآن!» أن تكون شخصية المعرض «نجيب محفوظ»، فذلك ليس تفصيلًا بروتوكوليًا. لأن «نجيب محفوظ» ليس كاتبًا عظيمًا نحتفى به، بل زمن كامل تعلّمنا فيه كيف نحيا داخل الحكاية دون أن نُفسد الواقع. هو الذى جعل الرواية بيتًا مصريًا واسعًا، له شرفاتٌ على الفلسفة، ونوافذُ على السياسة، وسلالمُ تؤدى إلى الأسئلة الكبرى، دون ضجيج.
وأن تصدر روايتى الأولى فى عام يكون فيه «محفوظ» بطلَ معرض الكتاب، فتلك ليست إلا «فلسفة المصادفة» التى تكلّم عنها المفكر «محمود أمين العالم»، أبى الروحى وأولُ مَن نصحنى بكتابة الرواية قبل عشرين عامًا لامتلاكى «النَفَسَ السردى» على حدّ قوله، واتفق معه الناقدُ الكبير «رجاء النقّاش»، رحمهما الله. لكننى تخوفتُ من اقتحام هذا العالم المشتجّر بالحياة، أنا التى أخافُ الحياةَ أكثر مما أخافُ الموت. وظللتُ ربع قرن أكتب الشعرَ والترجمات والنقد، وأصدرتُ أربعين كتابًا، ليس من بينها روايةٌ واحدة. وحين أتممتُ روايتى الأولى هذا العام، وسلمتُها للناشر، غمرنى شعور من يضع يده الصغيرة فى يد مدينة كاملة. على أننى لم أكن يومًا بعيدة عن الرواية. كنتُ أدور حولها. أختلسُ النظرَ إليها، فإذا ما بادلتنى النظرَ، أطرقتُ، وأغمضتُ عينى خجلا. وكلما همستْ لى: «اكتبينى الآن!»، همستُ لها: «لستُ مستعدة».
ترجمتُ روايات «فرجينيا وولف» التى هشّمت الزمنَ إلى تيار وعى، و«فيليب روث» الذى أوقفَ الإنسانَ عاريًا أمام تاريخه ليفضح وصمةَ العنصرية، و«تشيمامندا نجوزى أديتشى»، التى أعادت للسرد أخلاقَه دون وعظ، و«تشينوا آتشيبى» الذى أعادَ للإنسان المُستعمَر صوتَه المسلوب، وكتب من داخل الجرح لا من شُرفته العلوية. جميع من سبقوا، جعلوا الأدبَ فعلَ استعادة ومقاومة، لا زينةً. اكتشفتُ أننى سنواتِ هروبى من الرواية، كنت أتعلّم منهم، لا فنون السرد وأسرار اللغات، بل «الشجاعة». شجاعة خوض المجهول.
أستاذى «رجاء النقاش» لم يُغوِنى بالرواية، بل صالحنى عليها، وأزال خوفى منها. وبطل حياتى «محمود أمين العالم» لم يدفعنى للرواية بوصفه ناقدًا، بل حرّضنى عليها بوصفه مناضلًا يعرف أن الأفكار لا تكتمل إلا حين تُروى.
ومع ذلك، ظللتُ أؤجّل. كنتُ أعرف أن الرواية ليست جنسًا أدبيًا، بل مسؤولية وجودية. أن تكتبَ رواية، يعنى أن تضع مخاوفك على الطاولة، دون أقنعة الشعر. غرستُ بذرة الرواية فى تُربتى منذ خمسة عشر عامًا، وتركتُها دون رِىّ. كبرتُ، وتغيّر العالمُ، وتكسّرت أوهامى وأحلامى بأن أُصلحَ العالمَ ليصيرَ أجملَ وأكثرَ عدالةً ورحمة. بينما هى، الرواية، بقيت: صامتةً، صابرةً، حتى هذا العام؛ حين شعرتُ أن بوسعى فتح الباب دون خوف. وكانت «قبو الورّاق»، روايتى الأولى التى احتفى بها النقادُ فى قاعة «ملتقى الإبداع» بالمعرض. د. «فاطمة الصعيدى»، د. «مجدى نصّار»، والشاعر «شعبان يوسف»، ونخبة من المثقفين والأدباء الذين حضروا مناقشة وحفل توقيع الرواية، حوّلوا رهبتى من اقتحام «الرواية» إلى فرح واطمئنان.
معرض الكتاب هذا العام لم يكن إذن احتفالًا بالكتب فقط، بل احتفالٌ بالمسارات الطويلة، بالنصوص التى تأخرت وهى تنتظر أصحابها. أقفُ أمام روايتى كما تقف الأمُّ أمام طفلها الأول: دهشة، خوف، وفرح لا تصفه الكلماتُ. أتذكّر كل المعارض السابقة، التى جئتُ فيها قارئة، وشاعرة، ومترجمة، وأبتسم: لم أكن أعرف أننى كنتُ أتدرّب على هذه اللحظة.
فى حضرة «نجيب محفوظ»، وفى مدينة علّمت العالم كيف تُنجَبُ الحكاياتُ، أقولُ لمكتبتى: تأخّرتُ لأن الطريقَ كانت وعرة، ولأن الرواية لا تُكتب إلا حين يحين وقتُ نزيفها. هذا العام، لم آتِ إلى معرض الكتاب لأشترى كتبًا وأقول الشعر وأوقّع دواوينى وكتبى، بل لأُخرج روايتى الأولى من عتمة الانتظار إلى ضوء الرفوف. «قبو الورّاق» ليست حكاية كتبها خفقُ قلمى، بل نصٌّ صوفىّ يحفرُ فى الذاكرة المثقوبة، حين يتحوّل القبو إلى مسرح حلول لمواجهة النسيان والاغتراب، وساحة صراع الإنسان ضد محو هويته، حيث يصبحُ الحرفُ سلاحًا، والكلمةُ دِرعًا، واللغةُ فعل مقاومة ضد الإلغاء القسرى للوجود. وأما الكتبُ فهى الحياةُ التى تنطقُ بعد صمتها الطويل.
GMT 09:05 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
شرق المساكينGMT 09:04 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
آن للعالم أن يخرج من كذبة يعيش فيها!GMT 09:02 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
حين تحرّكت عقارب القيامة!GMT 09:01 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
السودان... الهدنة الهشة لا تعني السلام!GMT 08:59 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
رحلة العملاق!GMT 08:58 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
«أم الاتفاقات» مجرد بدايةGMT 08:56 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
هل يمكن للأصولية أن تستغلّ الفلسفة؟!GMT 08:55 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
ترمب الأول وترمب الثانيصندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل
القاهرة ـ مصر اليوم
رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في يناير 2026، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل. وتوقع صندوق النقد، أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 4.7% عام 2026/2025 و5.4% عام 2027/2026، وذلك بارتفاع قدره...المزيدماغي بوغصن تكشف تطور الدراما اللبنانية وتروي صعوبات طفولتها وتجاربها التعليمية والإبداعية
القاهرة ـ مصر اليوم
حلّت الفنانة ماغي بوغصن ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، حيث تحدثت عن رؤيتها للوسط الفني، مميزاته وتحدياته، مؤكدةً أن الساحة الفنية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات...المزيدواتساب يطلق ميزة أمان متقدمة لحماية قصوى ضد الهجمات الإلكترونية
واشنطن ـ مصر اليوم
كشف تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، يوم الثلاثاء ميزة أمان مُتقدّمة تحمل اسم "إعدادات الحساب الصارمة".وقال "واتساب"، في منشور على مدونته الثلاثاء، إن هذه الميزة تقدم حماية مشددة ض...المزيدمجمع الملك فهد يوزع مصحف المدينة للمكفوفين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الرياض ـ مصر اليوم
وزّع جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلًا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المشارك ضمن جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026م، في دورته السابعة والخمسين، مصحف المدينة النبوية ال�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©